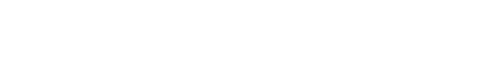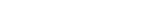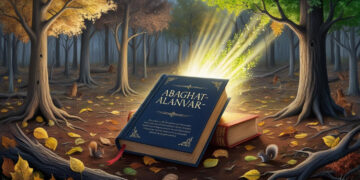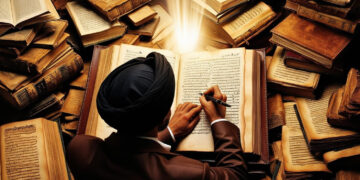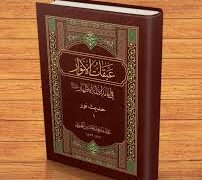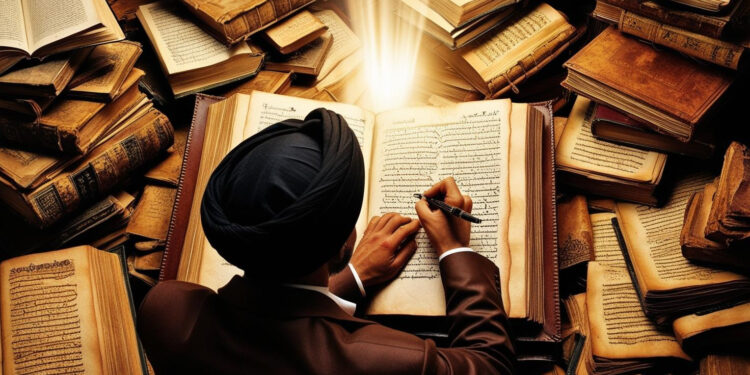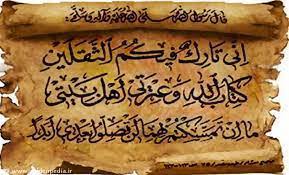ملخص”
“تتناول هذه المقالة تحليل ومقارنة المفاهيم الأساسية في الأحاديث المتعلقة بخلافة الإمام علي (عليه السلام) من منظور منهجية مير حامد حسين. باستخدام المبادئ التفسيرية والحديثية له، تقوم المقالة بدراسة دقيقة لدلالات حديث المنزلة وحديث الغدير، وتؤكد على كيفية فهم وتفسير هذه الأحاديث بناءً على منهجية مير حامد حسين، لا سيما من خلال استخدام قواعد “حمل على المعنى” و”حديث بعضهم يفسر بعضاً”. النقطة البارزة في هذه الدراسة هي التأكيد على منهجية مير حامد حسين في تحليل الدلالات الحديثية والتفسيرية، مما يسهم في إظهار أبعاد أعمق لمكانة الإمام علي (عليه السلام) في تاريخ الإسلام.”
“في البداية، بالاستناد إلى قاعدة «حمل على المعنى»، يتم تحليل الاختلافات الظاهرة بين أقوال النبي محمد (صلى الله عليه وآله) بشأن خلافة الإمام علي (عليه السلام) وأمثاله التاريخيين مثل هارون بالنسبة لموسى (عليه السلام). توضح هذه القاعدة أن الفرق الوحيد بين الإمام علي (عليه السلام) وهارون يكمن في مسألة النبوة، بينما تتشابه باقي الأبعاد مثل الأخوة، الوزارة، والخلافة.”
“أيضًا، باستخدام مبادئ علم الحديث واستنادًا إلى كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطي، يتم تقديم أمثلة على حمل العبارات على معاني مجازية وأعمق. تشير هذه الشواهد إلى أن بعض الجمل في الأحاديث النبوية قد تحتاج إلى تفسير مختلف عن المعنى الظاهر، لكي يتضح الهدف من رسالة النبي محمد (صلى الله عليه وآله) في نقل مفاهيم أعمق.”
فيما بعد، يتم تطبيق قاعدة “حديث بعضهم يفسر بعضاً” لفهم أدق لمعاني حديث غدير والاحاديث ذات الصلة. باستخدام هذه المنهجية، يستخرج الكاتب من جهة معنى أكثر دقة ووضوحًا للكلمات والجمل، ومن جهة أخرى، يوضح مفهوم الولاية والخلافة للأمير علي (عليه السلام) في سياق الأحاديث المعتبرة.
وفي النهاية، يتناول هذا المقال بالإشارة إلى قاعدة “ضرورة حمل اللفظ المشترك في حالة فقدان المخصص على جميع معانيه”، ويبحث في حديث “إن علياً مني وأنا من عليّ وهو ولي كل مؤمن من بعدي”، مؤكدًا على جميع معاني كلمة “ولي”. يظهر هذا التحليل أن كلمة “ولي” في هذا الحديث يجب أن تحمل معنى “الأولوية في التصرف” وبقية معانيها، لكي تقدم دلالة أدق على ولاية أمير المؤمنين علي (عليه السلام) على سائر المؤمنين.
هذا البحث يعكف بشكل علمي وموثق على دراسة النقاط التفسيرية وعلم الحديث في إطار القواعد الأصولية، ومن أجل الوصول إلى فهم أعمق لمكانة الإمام علي (عليه السلام) العلمية والدينية في تاريخ الإسلام، يعتبر التركيز على التفاصيل والتطبيقات المختلفة أمرًا ضروريًا.
الاستدلال بالحديث: دراسة صدوره، اعتباره ودلالته
للاستدلال بالحديث في أي موضوع، بالإضافة إلى التحقيق في صدور الحديث وإثبات صحته، يجب أيضًا أن يتم دراسة دلالته. الدلالة تعني ما يمكن فهمه من النصوص بناءً على قواعد اللغة، الأدب، والقرائن المختلفة. بعض النصوص المعتمدة، مثل آيات القرآن، هي محل اتفاق بين جميع الفرق الإسلامية. كما أن العديد من النصوص تُعد قطعية الصدور بسبب تواترها أو مصاحبتها لقرائن قطعية. ومع ذلك، فإن اليقين في صدور الحديث لا يُعفي الباحث من دراسة دلالته.
ضرورة دراسة دلالة الحديث: لماذا دلالة الحديث مهمة؟
تتجلى ضرورة هذا البحث عندما يتفق الجميع على صحة الحديث وقطعيته، ولكن يحدث الاختلاف في دلالته. في مثل هذه الحالات، يتم تقديم تفسيرات مختلفة للعبارات، التي قد تكون أحيانًا متناقضة مع بعضها البعض. هذا التعارض في الفهم قد يؤدي إلى إبطال صلاحية النص للاستدلال به. بعد دراسة سند الحديث وإثبات تواتره، قام المرحوم السيد مير حامد حسين الهندي بتحليل دلالات الأحاديث. في ما يلي، سوف نناقش منهجه في دراسة دلالات الأحاديث.
طريقة المرحوم مير حامد حسين في الاستدلال بالنصوص.
المرحوم مير حامد حسين في الاستدلال بالنصوص كان ملتزماً بقواعد التحقيق والمناظرة. الخطوط العامة لمنهجه في دراسة الدلالات هي كما يلي:
الاستدلال بأخبار أهل السنة لا بأخبار الشيعة.
هذه واحدة من قواعد التحقيق — بل وأهمها — ولذلك، يلتزم السيد بهذه القاعدة في جميع بحوثه. حتى في سير الأحداث التاريخية، يستند إلى أخبار أهل السنة. هذا الأمر يكون واضحًا تمامًا لأي شخص يطلع على هذا الكتاب من البداية إلى النهاية، ولا حاجة للإطالة في النقاش حوله.
الرجوع المباشر إلى كتب أهل السنة
مع ذلك، هو لا ينقل أخبار أهل السنة من خلال كتب الشيعة، بل ينقلها مباشرة من كتب أهل السنة — إلا في حالات نادرة. على سبيل المثال، لا يقول: «نقل مرتضى عن أحمد في مسنده أن…»، بل يعود إلى مسند أحمد نفسه أو ينقل الخبر عن شخص أو عدة أشخاص من أهل السنة.
الاستدلال بالمصادر والقواعد المقبولة من قبل الطرف الآخر
تُساهم هذه الطريقة في تقليل الخلافات والصراعات من خلال استخدام المصادر والمبادئ المعتبرة. من خلال بناء الثقة، وتقليل المقاومة النفسية، وتعزيز المنطق، تساعد الجمهور على اتخاذ قرارات أكثر صحة. ومع هذا النهج، يخرج النقاش من حالة المواجهة ويتحول إلى حوار بناء وعادل. النتيجة هي تقليل التوترات والوصول إلى فهم الحقيقة بعيداً عن التحيزات. وهذه الطريقة تعكس تسلط المرحوم مير حامد على الموضوع، مما يجعل الاستدلالات خالية من أي مغالطات.
الاستناد إلى الكتب المعتبرة لأهل السنة
هو لا ينقل من أي كتاب في مجال الأخبار والحديث ولا يعتمد عليه، بل يعتمد أكثر على نقل الأحاديث من أهم وأشهر كتب أهل السنة في الحديث. ومن بين هذه الكتب:
الصحاح الستة وشروحها، الموطأ وشروحه، الجمع بين الصحيحين. الجمع بین الصحاح الستة. معاجم الطبرانی.
المستدرک علی الصحیحین. و … .
هذه الأمور تتعلق بالأخبار والأحاديث. أما فيما يخص العلوم الأخرى فهو يرجع إلى كتب أهل السنة في كل علم وفن. على سبيل المثال، في التفسير، يرجع إلى كتب مثل:
تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي.
تفسير الجلالين.
في مجال السيرة وفضائل أهل البيت، على سبيل المثال، يرجع إلى كتب مثل:
السيرة النبوية المعروفة بسيرة ابن هشام.
إنسان العیون لنور الدین الحلبی. السیرة النبویة لأحمد زینی دحلان.
في مجال اللغة، يرجع إلى العديد من الكتب، ومنها ما يلي:
المبسوط لشمس الدین السرخسی. بدائع الصنائع للکاشانی. الهداية وشروحها.
في أصول الفقه، يرجع إلى هذه الكتب:
المختصر لابن الحاجب وشروحه.
الأصول للسرخسي.
الأصول للبزودي وشروحه.
في معرفة الأحاديث الموضوعة (المكذوبة)، المشهورة والمتواترة عن غيرها، يتم الرجوع إلى هذه المصادر:
الموضوعات لابن الجوزی. اللئالی المصنوعة للسیوطی. التعقبات علی الموضوعات للسیوطی.
في التعرف على الرواة الضعفاء، والوضاعين (المكذبين) والمدلسين (الذين يزوّرون في إسناد الحديث)، يتم الرجوع إلى هذه المصادر:
الضعفاء و المتروکین للبخاری. الضعفاء و المتروکین للنسائی. کشف الأحوال فی الرجال لعبد الوهاب المدراسی.
في مجال الدراية (علم دراسة وتحليل الأحاديث) وقواعد التحديث (قواعد نقل ورواية الحديث)، يتم الرجوع إلى هذه المصادر:
علوم الحدیث لابن الصلاح. التقیید و الإیضاح للزین العراقی. التقریب للنووی.
في مجال علم الكلام (اللاهوت والمسائل العقائدية)، يتم الرجوع إلى هذه المصادر:
شرح المقاصد للتفتازانی. شرح المواقف للجرجانی. شرح التجريد للقوشچی.
في مجال تراجم العلماء (السير الذاتية وشرح حال العلماء)، يتم الرجوع إلى هذه المصادر:
اتحاف الوری بأخبار أم القری لابن فهد المکی. أخبار الأخیار لعبد الحق الدهلوی. أخبار أصبهان لأبی نعیم الحافظ.
في مجال غريب الحديث (الألفاظ الصعبة والنادرة في الأحاديث) وعلوم العربية (العلوم المتعلقة باللغة العربية)، يتم الرجوع إلى هذه المصادر:
النهایة لابن الأثیر. الفائق للزمخشری. مجمع البحار للفتنی.
وكذلك، في كتب الأخلاق، التصوف، السلوك، وحتى في كتب المحاضرات، الطرائف، القصص، والأدب، في جميع هذه المجالات، يرجع إلى كتب أهل السنة.

تأكيد على اعتبار المصادر: أساليب المرحوم مير حامد حسين
المرحوم مير حامد حسين كان يولي أهمية كبيرة للمصادر المعتبرة في استدلالاته. كانت طريقته تتمثل في الاعتماد على الكتب الموثوقة والمعترف بها من قبل أهل السنة والجماعة في مختلف العلوم. من خلال هذه الطريقة، كان يسعى لتحقيق موضوعية وحيادية في نقله للأخبار والآراء، مما يساهم في تقليل الخلافات وإثراء النقاشات.
في العديد من الحالات، كان يُؤكّد على اعتبار الكتاب الذي ينقل منه أو يستشهد به. كانت طريقته في هذا المجال كما يلي:
1-ذكر قول كاشف الظنون:
بهذه الطريقة، يثبت اسم الكتاب واسم مؤلفه وصحة نسب الكتاب إلى مؤلفه.
كتاب “كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون” من تأليف حاجي خليفة، يُعد من أهم المصادر في فهرسة الكتب الإسلامية. طريقة حاجي خليفة في هذا الكتاب لإثبات اسم الكتاب، اسم المؤلف، وصحة نسب الكتاب إلى المؤلف هي كما يلي:
1.الإحالة إلى المصادر المعتبرة: استخدام المصادر التاريخية وفهارس الكتب القديمة لتوثيق المعلومات.
2ذكر الشواهد والقرائن: تقديم شواهد مثل الاقتباسات والوثائق التاريخية لإثبات نسبة الكتاب.
3دراسة السند والرواة: تحليل السند والرواة في حال وجودهم، لتوثيق صحة الكتاب.
4المقارنة مع آثار أخرى للمؤلف: مقارنة محتوى وأساليب الكتاب مع أعمال أخرى للمؤلف لتوثيق نسبته.
5ذكر آراء العلماء الآخرين: الاستفادة من آراء العلماء الآخرين كدليل لتوثيق أو رفض النسبة.
2ذكر رواية العلماء عن الكتاب في كتب الإجازات والإسانيد.
يُؤكد هذا العمل مصداقية الكتاب من خلال الاقتباسات التي نقلها العلماء الآخرون واعتمدوا عليها.
3ذكر من نقلوا عن الكتاب و اعتمدوا عليه.
تُظهر هذه الطريقة أن الكتاب كان موثوقًا به لدى العلماء الكبار.
4ذكر من جعلوا الكتاب من مصادرهم و صرحوا به في مقدمة كتبهم.
يُظهر هذا العمل الاستخدام الواسع للكتاب بين العلماء.
5مقدمة الكتاب:
في مقدمة الكتاب، يتعهد المؤلف بأنه نقل من الكتب المعتبرة وأورد الأخبار الموثوقة.
تأثير هذه الطريقة في المناظرة والبحث:
بالإضافة إلى أن تأثير هذه الطريقة في الوصول إلى الهدف والكفاءة في المناظرة لا يُخفى، فإن الكاتب من خلال التأكيد على اعتبار الكتب والمصادر من وجهة نظر المخالفين، يُظهر التزامه بالأمانة العلمية والصدق والتمسك بالبحث عن الحقيقة. من خلال ذكر المصادر بدقة والابتعاد عن التزوير، يلتزم بالمسؤولية تجاه الحقيقة. كما أنه من خلال خلق بيئة منصفة، يعزز العدل والإنصاف في النقاش. هذه الطرق لا تعزز مصداقية الاستدلالات فقط، بل تسهم أيضًا في التقدم العلمي والاجتماعي. هذا النهج يُعد نموذجًا أخلاقيًا لكل باحث.
جواب المرحوم مير حامد حسين على ادعاءات المتعصبين:
بعض المتعصبين من أهل السنة، عن جهل أو تجاهل، قالوا إن الاستدلال بكتب المخالفين دليل على أن الشيعة لا يملكون كتبًا أو روايات أو علماء، وأنهم في كل ما يدّعونه محتاجون إلى أهل السنة. قال ابن روزبهان ردًا على العلامة الحلّي:
“عجب من هذا الرجل الذي لا ينقل حديثًا إلا من جماعة أهل السنة، لأن الشيعة لا يملكون كتابًا أو رواية أو علماء مجتهدين يستخرجون الأخبار. لذلك، هو في إثبات ادعاءاته محتاج إلى أهل السنة.”
سيد رحمه الله لم يكن غافلًا عن هذا التوهم أو التجاهل. ولذلك، في مناقشته لبعض الأحاديث (مثل حديث النور)، نقل ألفاظًا من خلال الشيعة الإمامية، من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ومن النبي الرحمة (صلى الله عليه وآله)، ليكون ردًا على كلام ابن روزبهان وأتباعه. هذا العمل يظهر تسلطه على مصادر الشيعة وأهل السنة، وقدرته على استخدام كلا المصدرين لإثبات صحة استدلالاته.
الاستناد إلى فهم الصحابة: مفتاح لفهم الحديث النبوي
إحدى الطرق المهمة في الاستدلالات العلمية والدينية هي الرجوع إلى فهم الصحابة. الصحابة للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وخاصة أولئك الذين اختلفوا في بعض الأحيان مع الإمام علي (عليه السلام)، يُعتبرون مرجعًا وحجة في المنازعات والخلافات حول تفسير الحديث النبوي. هذه المسألة لها أهمية من عدة جوانب:
ومن طرقه في الاستدلال لإثبات وجهة نظره، الرجوع إلى فهم الصحابة. لأن فهم الصحابة — وخاصة أولئك الذين اختلفوا مع علي (عليه السلام) — في المنازعات والخلافات حول معنى الحديث النبوي، يُعد حجة ومرجعًا. وهذه المسألة لعدة أسباب:
1لأنهم عند أشهر أهل السنة، عدول.
2لأنهم كانوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وآله، وشاركوا في الوقائع. كانوا شهودًا على صدور الحديث محل النزاع، وسمعوه وحفظوه.
3ولأنهم أهل اللغة (فهم دقيق للغة العربية).
لذا من المناسب الرجوع إلى فهمهم. وهذا هو ما قام به السيد في بعض بحوثه. هنا نذكر بعض الأمثلة على ذلك:
نماذج من الاستناد إلى فهم الصحابة:
لذا من المناسب الرجوع إلى فهمهم. وهذا هو ما قام به السيد في بعض بحوثه. هنا نذكر بعض الأمثلة على ذلك:
في معنى “من كنت مولاه فهذا علي مولاه”
الصحابة فهموا مما قاله النبي صلى الله عليه وآله في يوم غدير خم نفس المعنى الذي يعتقده الشيعة:
أمير المؤمنين عليه السلام سأل الناس عن (حديث غدير) وطلب من الذين كانوا حاضرين في ذلك اليوم وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وآله أن يشهدوا.
هل تعتقدون أنه عليه السلام فهم من هذا الحديث شيئًا غير الإمامة؟
2وإذا كان المقصود من (حديث غدير) شيئًا غير “الإمامة” من معاني “الولاية”، فلماذا امتنع بعض الصحابة عن الشهادة؟ ولماذا دعا عليهم عليه السلام بدعاء سوء لأولئك الذين لم يشهدوا؟
3ولماذا “سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ وَاقِعٍ، لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ” (سورة المعارج، الآية 1) …
هل فهم “الإمامة” من خطبته؟ أليست قد قال للنبي: “… ثم لم ترضَ بذلك حتى رفعت يد ابن عمك وفضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه…”؟
4وقال حسان بن ثابت الأنصاري في شعره في يوم غدير:
«رضیتک من بعدی اماماً و هادیاً»
5وأنكر أبو طُفيل (حديث غدير) وقال: “خرجت وكان في نفسي شيء.”
6ودخل أبو أيوب الأنصاري ومجموعة من الصحابة على أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا: السلام عليك يا مولانا. فقال عليه السلام: كيف أكون مولاكم وأنتم عرب؟ فقالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم غدير خم يقول: “من كنت مولاه فعلي مولاه”.
7وهنّأ أبو بكر وعمر وبقية الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وآله عليًا في يوم غدير وقالوا: “يهنئك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة…”
8وقال عمر ردًا على من قال له: “تفعل مع علي ما لا تفعله مع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله”، قال: “هو مولاي”.
9وقال لمن امتنع عن قضاء علي: “ويحك! ألا تعلم من هذا؟ هذا مولاي”.
10وقال ابن حجر المكي في (الصواعق) في وجوه الرد على حديث غدير:
«الوجه الثالث: نحن نقبل أنه أولى، ولكن لا نقبل أن المقصود بالأولى هو الإمامة، بل المقصود بالأولى هو الأفضلية في الاتباع والقرب منه، مثل قوله تعالى: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ (سورة آل عمران، آية 68). ولا يوجد دليل قطعي أو حتى ظاهر لدفع هذا الاحتمال. بل هذا هو ما فهمه أبو بكر وعمر، وقد ورد ذلك في الحديث المعروف. لأنهما عندما سمعاه قالا له: يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. رواه الدارقطني. وقد نقل أيضًا أنه قيل لعمر: أنت تفعل مع علي ما لا تفعله مع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: هو مولاي.»

حديث الطائر: نظرة عميقة إلى أحب مخلوق إلى الله
حديث الطائر هو أحد الأحاديث المشهورة والمثيرة للجدل في تاريخ الإسلام الذي تم تفسيره بطرق مختلفة. في هذا الحديث، يدعو النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) قائلاً:
«اللهم ائتني بأحب خلقك إليك و الى رسولك يأكل معي من هذا الطائر»
(خدایا، محبوبترین مخلوقت را نزد خودت و رسولت به سوی من بفرست تا با من از این پرنده بخورد).
الدهلوي، أحد المفسرين، ادعى أن المقصود من “أحب” في هذا الحديث هو “أحب في الأكل”. ولكن هذا التفسير واجه تحديات كبيرة، خاصةً بالنظر إلى فهم الصحابة والرويات التاريخية التي تظهر أن المقصود من “أحب” هو شيء أبعد من مجرد الأكل.
جواب السيد رحمه الله على ادعاء الدهلوي:
السید رحمه الله قد ردَّ على دعوى الدهلوي بسبعين وجهًا. ومن أهم هذه الوجوه الرجوع إلى فهم الصحابة، إذ إنّ صحابة النبي (صلى الله عليه وآله) قد فهموا من هذا الحديث عين ما يعتقده الشيعة، وهو أنّ الإمام عليًّا (عليه السلام) أحبّ الخلق إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وإلى الله تعالى.
روایةُ مالِکِ بنِ أنسٍ: شاهِدٌ تاریخيٌّ
روایةُ مالِكِ بنِ أنسٍ تُبیِّنُ بِوُضُوحٍ كیفَ فَهِمَ الصَّحابةُ هذا الحَدیثَ. وقد جاءَ في هذِهِ الرِّوایةِ:
«أُهدِيَ إلى رسولِ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) حَجلٌ مَشويّ، فقال النبيُّ (صلى الله عليه وسلم): اللهمَّ، أرسِلْ إليَّ أحبَّ خَلقِكَ إلَيكَ ليأكُلَ معي من هذا الطَّعام. فقالَت عائشةُ: اللهمَّ، اجعَلْه أبي. وقالت حفصةُ: اللهمَّ، اجعَلْه أبي. وقال أنسٌ: قلتُ: اللهمَّ، اجعَلْه سعدَ بنَ عُبادة.»
لكن في النهاية، كان الإمامُ عليٌّ (عليه السلام) هو الذي استجابَ لدعوةِ النبيِّ (صلى الله عليه وآله) ودخلَ عليه. وهذه الروايةُ تدلُّ بوضوحٍ على أنَّ الصحابةَ كانوا على علمٍ بأنَّ الإمامَ عليًّا (عليه السلام) هو أحبُّ الخلقِ إلى اللهِ تعالى.
أسئلة رئيسية حول تفسير الدهلوي
۱. هل شوق عائشة وحفصة وأنس لأن يكون “الأحب في الأكل” غير علي أمر طبيعي؟
إذا كان المقصود من «أحب» هو مجرد الأحب في الأكل، فلماذا كانت عائشة وحفصة وأنس متحمسين جدًا لأن يكون شخص آخر غير الإمام علي (عليه السلام) في هذه المنزلة؟ أليس هذا دليلًا على أنهم أيضًا كانوا يعلمون أن «أحب» يعني الأحب عند الله ورسوله؟
2-ما الضرر لو كان عليٌّ (عليه السلام) «أحبّ في الأكل»؟
إذا كان المقصود من الحديث مجرد الأكل، فلماذا كانت هذه المسألة مثيرة للحساسية إلى هذا الحد؟ أليس هذا دليلًا على أن الحديث يشير إلى مسألة أهم بكثير من مجرد وجبة طعام؟
3-هل كان أنس بن مالك ليرتكب كذبة كبيرة من أجل مسألة صغيرة كهذه؟
أنس بن مالك في روايته يوضح بجلاء أن الإمام عليًا (عليه السلام) هو من لبى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن تصور أن أنس كذب من أجل مثل هذا الموضوع؟ هذا يدل على أن الحديث يشير إلى موضوع أهم بكثير من مجرد الطعام.
صلة حديث الطائر بوصية النبي (صلى الله عليه وآله)
تُذْكِرُ هذه الحادثة بوصية النبي (صلى الله عليه وآله) في أيام مرضه. في ذلك الوقت، أمر النبي بدعوة الإمام علي (عليه السلام) لكتابة الوصية وإقامة الصلاة. ولكن عائشة وحفصة اقترحتا أن يتم دعوة أبو بكر أو عمر. هذه المقارنة تُظهر أن الإمام علي (عليه السلام) كان دائماً أقرب وأحب شخص للنبي.
رواية ابن عباس وعائشة
في رواية عن ابن عباس جاء:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أرسلوا إلى علي وادعوه.” فقالت عائشة: “إن أرسلته إلى أبي أفضل.” وقالت حفصة: “إن أرسلته إلى عمر أفضل.”
تُظهر هذه الرواية أنه حتى في اللحظات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الإمام علي عليه السلام يُعتبر أكثر الأشخاص محبة لديه.
فهم الصحابة هو المفتاح لحل اللغز.
فهم الصحابة من حديث الطائر وأحاديث مشابهة يُظهر بوضوح أن الإمام علياً (عليه السلام) كان أحب مخلوق إلى الله ورسوله (صلى الله عليه وآله). تفسير دهلوي الذي يعتقد أن “أحب” تعني الأكثر حباً في الأكل لا يتوافق مع الشواهد التاريخية والروائية. لذلك، الرجوع إلى فهم الصحابة والأحاديث التاريخية هو المفتاح لفهم صحيح لهذا الحديث ولتأكيد مكانة الإمام علي (عليه السلام) الفريدة عند الله سبحانه وتعالى ورسول الرحمة.
تحليل ثلاثة أحاديث مهمة عن الإمام علي (عليه السلام)
في الأحاديث الإسلامية، هناك ثلاثة أحاديث مهمة تُظهر المكانة الخاصة للإمام علي (عليه السلام) عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفي النظام الإسلامي. وهذه الأحاديث هي:
١. حديث الولاية: «من كنت مولاه فعلي مولاه»
٢. حديث الراية: «سأعطي الراية لرجُلٍ يحبّ الله ورسوله.»
«حديث المنزلة: “أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.”»
هذه الأحاديث لا تؤكد فقط مكانة الإمام علي (عليه السلام) كخليفة للنبي (صلى الله عليه وآله) بل أيضاً تُظهر ولايته، محبته، و منزلته في الإسلام. سنقوم في ما بعد بتحليل هذه الأحاديث وفهم الصحابة لها.
١. حديث الولاية: «من كنت مولاه فعلي مولاه»
هذا الحديث الذي ورد في غدير خم يُعَدُّ من أهم الأحاديث حول إمامة وولاية الإمام علي (عليه السلام). فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في هذا الحديث:
«من کنت مولاه فعلی مولاه»
«من کنت مولاه فعلی مولاه»
فهم الصحابة لحديث الولاية
سعد بن أبي وقاص يروي في حديثٍ أن معاوية طعن في الإمام علي (عليه السلام)، لكنه ردّ عليه بغضب قائلاً:
“أتقول هذا عن رجلٍ سمعتُ رسولَ الله (صلى الله عليه وسلم) يمنحه ثلاثَ خصالٍ، وقال: لو كانت لي واحدةٌ منها لكانت أحبَّ إليَّ من الدنيا وما فيها.”
سعدٌ ثم أشارَ إلى حديثِ الولايةِ وأكَّدَ أنَّ هذا الحديثَ يدلُّ على ولايةِ الإمامِ عليٍّ (عليه السلام).
السؤالُ الرئيسيُّ
هل يمكن تصوّر أن يكون مقصود النبي (صلى الله عليه وآله) من “مولى” شيئًا غير الولاية والقيادة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا استدلّ الصحابة، كـسعد بن أبي وقاص، بهذا الحديث على تفوّق الإمام علي (عليه السلام)؟
٢. حديث الراية:
«سأعطي الراية لرجُلٍ يحبّ الله ورسوله.»
هذا الحديث أيضًا من علامات محبة ومكانة الإمام علي (عليه السلام) الخاصة. قال النبي (صلى الله عليه وآله):
«سأعطي الراية لرجُلٍ يحبّ الله ورسوله.»
ثمّ دفع الراية إلى يد الإمام علي (عليه السلام).
فهم الصحابة لحديث الراية
ذكر سعد بن أبي وقاص هذا الحديث كأحد الثلاثة صفات العليا للإمام علي (عليه السلام). يوضح هذا الحديث أن الإمام علي (عليه السلام) لم يكن فقط محبوبًا لدى الله ورسوله، بل كان أيضًا مؤهلاً للقيادة وحمل راية الإسلام.
السؤالُ الرئيسيُّ
إذا كان المقصود من هذا الحديث مجرد مسألة عسكرية، فكيف يمكن للنبي (صلى الله عليه وآله) أن يذكره كأحد أبرز صفات الإمام علي (عليه السلام)؟ أليس هذا يدل على مكانته القيادية وولايته؟
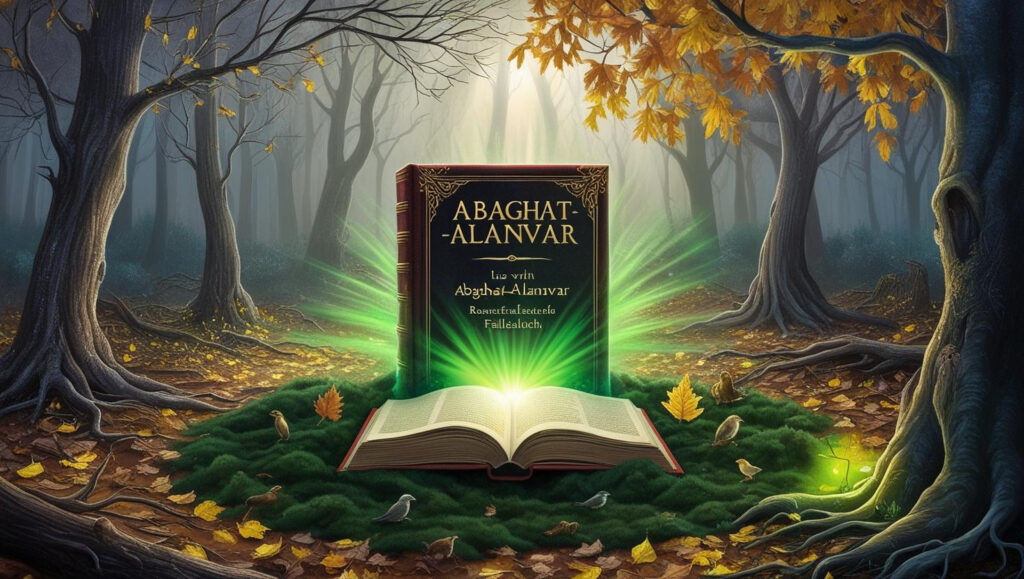
«حديث المنزلة:
“أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.”»
هذا الحديث الذي الحديث المعروف بمنزلة الإمام علي (عليه السلام) يوضح مكانته كـوزیر وزيرًا وخليفةً للنبي (صلى الله عليه وآله) يظهر مكانته. قال النبي (صلى الله عليه وآله):
“أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.”»
فهم الصحابة من حديث المنزلة
معاوية بالرغم من عدائه وعداوته لأمير المؤمنين عليه السلام، يفهم من حديث المنزلة أحقية أمير المؤمنين علي عليه السلام في العلم والفضل.
وحتى في رده على من طلب منه أن يجيب بدلاً من الإمام علي (عليه السلام)، قال:
«لقد قلت قولاً سيئًا! أنت تكره الرجل الذي ملأه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالعلم الوفير.»
هذا يدل على أن حتى معاوية كان يعترف بعلم ومنزلة الإمام علي (عليه السلام). وقد نقل ابن حجر المكي وغيرهم (وكانت العبارة منه): “أحمد رواه أن رجلاً سأل معاوية، فأجاب: اسأل علياً، لأنه أعلم. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين! جوابك أحب إلي من جواب علي. فقال معاوية: ما قلت قولاً سيئاً! أنت تكره رجلاً ملأه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالعلم الكثير. وقال له رسول الله: ‘أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي.’ وكان عمر كلما وقع في مسألة غامضة، يسأل علياً ويأخذ برأيه.”
روايات اخرى مشابه قد وردت، ولكن البعض منها أضاف أن معاوية قال لذلك الرجل: “قم! لا يثبت الله قدميك، وأزال اسم ذلك الرجل من الديوان.” وكان عمر أيضا يسأل عليا (عليه السلام) ويستفيد منه. وأنا نفسي قد رأيت أنه كلما واجه عمر مشكلة، كان يقول: “هل علي هنا؟”
السؤالُ الرئيسيُّ
إذا كان المقصود من هذا الحديث مجرد تشبيه بسيط، فلماذا اعترف معاوية وآخرون بعلم وإلمام الإمام علي (عليه السلام)؟ ألا يدل هذا على مكانته الخاصة كخليفة للنبي (صلى الله عليه وآله)؟
ولاية، محبة ومنزلة الإمام علي (عليه السلام)
تُظهر هذه الأحاديث الثلاثة بوضوح أن الإمام علي (عليه السلام) يتمتع بمكانة خاصة في الإسلام. حديث الولاية يؤكد على قيادته وولايته، وحديث الراية يدل على محبته وكفاءته في القيادة العسكرية والدينية، وحديث المنزلة يشير إلى مكانته كوزير وخليفة للنبي (صلى الله عليه وآله).
فهم الصحابة من هذه الأحاديث يؤكد أيضًا أنهم اعتبروها دليلًا على فضل الإمام علي (عليه السلام). حتى أولئك الذين كان لهم خلاف مع الإمام علي مثل معاوية، اعترفوا بعلمه ومكانته. لذلك، هذه الأحاديث لا تقتصر فقط على تأكيد مكانة الإمام علي (عليه السلام) كأحب مخلوق إلى الله ورسوله، بل تؤكد أيضًا على ضرورة اتباعه كخليفة شرعي للنبي (صلى الله عليه وآله).
في معنى حديث التشبيه
أبو بكر فهم من حديث التشبيه نفس ما تفهمه الإمامية.
في حديث عن الحارث الأعور جاء فيه:
بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ فِي جَمْعٍ مِنْ أَصْحَابِهِ:
«أُرِيكُمْ آدَمَ فِي عِلْمِهِ، وَنُوحًا فِي فَهْمِهِ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي حِكْمَتِهِ.»
«فَجْأَةً ظَهَرَ عَلِيٌّ (عَلَیْهِ السَّلَام).»
قال أبو بكر: «يا رسول الله، أتشبّه رجلًا بثلاثة أنبياء؟! هنيئًا لهذا الرجل! من هو، يا رسول الله؟»
فقال النبي (صلى الله عليه وآله): «ألا تعرفه، يا أبا بكر؟»
قال أبو بكر: «الله ورسوله أعلم.»
«فَقَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ): هُوَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.»
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: نَعِمَّا بِكَ یَا أَبَا الْحَسَنِ! وَ أَیْنَ مِثْلُكَ یَا أَبَا الْحَسَنِ؟!
الاستدلال بالقواعد المقررة
في كل علم من العلوم، توجد قواعد مقررة ومتفق عليها بين علماء ذلك العلم، ولا ينبغي لأي استدلال أن يكون متناقضًا مع أي من هذه القواعد، بل يجب أن يكون متوافقًا معها. وإلا، فلن يكتمل الاستدلال، ولن يصل إلى النتيجة المطلوبة.
ولا تجد في أي من استدلالات صاحب عبقات مخالفة لأي من القواعد المسلّمة في أي علم من العلوم. بل على العكس، في كل حالة تحتاج إلى تحقيق، تجد استدلالًا قويًا مبنيًا على القواعد العلمية المتفق عليها بين العلماء. وعندما يستند إلى قاعدة معينة، فإنه يشير إلى مراجع من استدلالات كبار العلماء في كتبهم المختلفة لإثبات صحة تلك القاعدة. وفيما يلي بعض من هذه القواعد:
قاعدة “تقديم المثبت على النافي”
في الروايات والنقولات، أحيانًا توجد تعارضات واختلافات تؤثر على فهم دلالة الرواية. في مثل هذه الحالات، يقوم المحقق بالرجوع إلى المرجحات، القرائن والأدلة لاستخراج النص الصحيح. وفي هذا الإشكال، يعتبر الإمام فخر الرازي عدم نقل الحديث من قِبل بعض الأشخاص دليلًا على كذب الحديث أو عدم أصالته. وفي هذا السياق، يرد المرحوم مير حامد حسين هندي على ادعاء فخر الرازي بالاستناد إلى القاعدة: «تقديم المثبت على النافي» يستدل به. وفقًا لهذه القاعدة، قول من نقل حادثة أو رواية مقدم على قول من سكت عنها أو نفى حدوثها.
هذه قاعدة عامة استند إليها السيد في رده على مناقشات الفخر الرازي حول حديث غدير. من بين أقوال الرازي كان أن البخاري ومسلم لم يرويَا حديث غدير. وقد أجاب السيد على كل جزء من أقواله في فصل منفصل يتضمن معلومات قيمة، ومباحث مهمة، ووجوه متعددة.
أحد هذه الوجوه هو تقديم قول الرواة الذين نقلوا حديث الغدير على قول من أنكره – وحتى من سكت عنه – استنادًا إلى قاعدة “تقديم المثبت على النافي”. وهذه قاعدة استند إليها المحدثون، والفقهاء، والأصوليون، والأدباء
أمثلة تطبيق قاعدة “تقديم المثبت على النافي”
١. صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) في الكعبة
في كتاب “السيرة الحلبية” في مناقشة حول ما إذا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد صلى في الكعبة يوم فتح مكة أم لا، جاء:
«بلال (رضي الله عنه) هو الذي يثبت الصلاة في الكعبة، وأسامة ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي.»
٢. كيفية جلوس النبي (صلى الله عليه وآله) في الصلاة
في كتاب “زاد المعاد في هدي خير العباد” — فيما يخص كيفية جلوس النبي (صلى الله عليه وآله) في الصلاة وهل كان يشير بها عند الدعاء أم لا — تم ذكر حديثين:
واحد من حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير الذي جاء فيه: “لم يكن يحركها”.
الآخر من حديث أبي حاتم عن وائل بن حجر الذي جاء فيه: “وكان يحركها”.
ثم أجاب على الأول وقال:
«وكذلك في حديث أبو داود لم يُذكر أنه كان في الصلاة، فإذا كان في الصلاة، كان نافيًا، وحديث وائل مثبت، والمثبت مقدم.»
٣. دراسة كلمة «مشورة»
في كتاب «الفتح الوهبي»، أيضًا، في دراسة ما إذا كانت كلمة «مشورة» كلمة واحدة أو كلمتين، نقل عن بعض علماء اللغة أنها كلمة واحدة، ومن آخرين أنها كلمتان.
ثم قام بتفضيل القول الثاني وقال:
«و المثبت مقدم على النافي، ومن حفظ الحجة على من لم يحفظ.»
قاعدة “تقديم المثبت على النافي” وحديث غدير
استنادًا إلى القاعدة التي تسري بين كبار المخالفين أيضًا، يظهر جهل أو تجاهل الفخر الرازي بوضوح. تجاهل كان يسعى إلى محو حقيقة بحجم حديث الغدير. القاعدة «تقديم المثبت على النافي» يُظهر بوضوح أن الروايات المثبتة حول حديث الغدير — التي نقلها رواة متعددون وموثوقون — تُقدّم على إنكار أو سكوت البعض الآخر. هذه القاعدة لم تُقبل فقط بين الشيعة، بل أيضًا بين علماء أهل السنة. وبالتالي، فإن ادعاءات الفخر الرازي بشأن عدم صحة حديث الغدير تُرفض بناءً على هذه القاعدة العلمية والمقبولة، ويُؤكد مكانة هذا الحديث كأحد أهم الأدلة على ولاية الإمام علي (عليه السلام).
قاعدة “عدم حمل الاستثناء على المنفصل في حالة إمكانية الحمل على المتصل”
تعريف القاعدة:
هذه القاعدة تشير إلى أنه إذا كان هناك استثناء في جملة ما، يجب في البداية اعتباره متصلاً، إلا إذا كانت هناك قرائن قاطعة تدل على أنه يجب اعتباره منفصلاً. منفصل. دلیل هذه القاعدة هو أن الاستثناء المتصل الحقيقة والاستثناء المنقطع مجاز، والأصل في الكلام هو حمله على الحقيقة إلا إذا وُجد دليل يخالف ذلك.
مبادئ القاعدة العلمية
١. الحقيقة والمجاز في علم الأصول
القاعدة الأساسية هي أن الكلمات والجمل تُستخدم في معناها الحقيقي، إلا إذا كانت هناك قرائن قطعية تشير إلى أنها تُستخدم بمعنى مجازي.
٢. الاقتصاد اللغوي:
قاعدة «عدم حمل الاستثناء على المنفصل» تعتمد على مبدأ الاقتصاد اللغوي، أي أن المتحدث يسعى لنقل رسالته بأقل قدر من الغموض وأقصى قدر من الدقة.
۳. القرائن النصية والحالية:
لتحديد ما إذا كان الاستثناء متصلاً أو منفصلاً، يجب الانتباه إلى القرائن النصية (مثل هيكل الجملة) والقرائن الحالية (مثل ظروف الكلام).
تطبیق القاعدة على حديث المنزلة
حديث المنزلة
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»
تحليل الاستثناء في الحديث
في هذا الحديث، الاستثناء «إلا أنه لا نبي بعدي» موجود. السيد يستدل بأن هذا الاستثناء يجب أن يُعتبر متصلًا، لأن:
۱. “عدم وجود قرائن قطعية”
لا توجد أي قرينة في الحديث تشير إلى أنه يجب اعتبار الاستثناء على أنه منقطع.
۲. حمل على الحقيقة
الأساس في الكلام هو الحمل على الحقيقة والاستثناء المتصل هو الحقيقة.
التناسق المعنوي.
إذا تم اعتبار الاستثناء على أنه متصل، فإن الحديث يصبح متماسكًا وبدون تناقض في معناه.
“معنى الحديث بالاستثناء المتصل”
“إذا تم اعتبار الاستثناء متصلاً، فإن معنى الحديث سيكون:”
“الإمام علي (عليه السلام) من جميع الجوانب مثل هارون بالنسبة إلى موسى، إلا في النبوة، لأنه بعد النبي محمد (صلى الله عليه وآله) لن يأتي أي نبي.”
“في هذه الحالة، الاستثناء يشير فقط إلى الفرق في مسألة النبوة، بينما تظل باقي أوجه التشبيه (مثل الأخوة، الوزارة، الخلافة، والمساعدة) كما هي.”
“باقي المنازل من قبيل النبوة.”
“النبوة مستثناة من باقي المنازل. في حالة الاستثناء المتصل، النبوة من جنس باقي المنازل التي لم يتم استثناؤها. وبناءً على ذلك، فإن المنازل التي لم تُستثنَ جميعها من المناصب الإلهية التي لا يمكن لأي إنسان عادي أن يشارك فيها دون اختيار إلهي.”
“معنى الحديث بالاستثناء المنقطع”
“إذا تم اعتبار الاستثناء منقطعًا، فإن معنى الحديث يتغير:”
“الإمام علي (عليه السلام) من جميع الجوانب مثل هارون بالنسبة إلى موسى، ولكن اعلموا أنه بعدي لن يأتي أي نبي.”
في هذه الحالة، يُعتبر الاستثناء جملة مستقلة تؤكد على ختم النبوة، ولا يوجد ارتباط مباشر مع تشبيه علي (عليه السلام) بهارون. في هذه الحالة، لا يبقى هناك ارتباط أو تناسب بين النبوة والمنازل التي لم يُستثنَ منها. النبوة هي مقام لا علاقة له بالمنازل الأخرى، ولا يُلزَم أن تكون جميع المنازل في وجود أمير المؤمنين (عليه السلام). هذه هي الغاية التي يريد دهلوي الوصول إليها من خلال طرحه لمناقشة الاستثناء المنقطع.
جواز الاستثناء المنقطع
الاستثناء المنقطع لا يمكن أن يكون إلا له استعمال مجازي، بمعنى أن الاستثناء لم يُوضَع لكونه منقطعًا. أي لا ينبغي أن نعتبر الاستثناء نوعين: أحدهما متصل والآخر منقطع. كما أنه لا أحد يعتبر المعنى المجازي جزءًا من أقسام المعنى الحقيقي للكلمة. على سبيل المثال، لا أحد يقول إن كلمة «أسد» لها معنيان: أحدهما بمعنى الأسد (الحيوان المفترس) والآخر بمعنى الرجل الشجاع. وبالتالي، كما أن كلمة «أسد» لا تعني أبدًا الرجل الشجاع، فإن الاستثناء أيضًا لا يعني أبدًا المنقطع، إلا إذا كان هناك قرينة أو دليل يُقدّم يثبت أن الاستثناء قد استُعمل في غير ما وُضِع له (مجازًا).
استدلال میر حامد حسین بالقاعدة.
المرحوم میر حامد حسین (ره) باستخدامه قاعدة «عدم حمل الاستثناء على المنفصل في حال إمكان حمله على المتصل»، يثبت أن الاستثناء في هذا الحديث يجب أن يُعتبر متصلًا. وهو يستدل قائلاً:
۱. الاستثناء المتصل هو الحقيقة.
الأساس في الكلام هو الحمل على الحقيقة والاستثناء المتصل هو الحقيقة.
2.الاستثناء المنقطع مجاز.
الاستثناء المنقطع مجاز وهو لا يُستخدم إلا في الحالات التي تدل فيها القرائن القطعية على ذلك.
3.عدم وجود قرائن قطعية.
في هذا الحديث، لا توجد أي قرينة تدل على أن الاستثناء يجب أن يُعتبر منقطعًا.
مصادر أصولية المخالفين
استند میر حامد حسین إلى مصادر موثوقة مثل «المختصر» لابن حاجب، «المنهاج» للبیضاوي، «التلويح» للتفتازاني، و «كشْف الأسرار في شرح أصول البزودي» لعبد العزيز البخاري. هذه المصادر أكدت على قاعدة «عدم حمل الاستثناء على المنفصل في حال إمكان حمله على المتصل» واعتبرتها قاعدة أصولية معتمدة.
قاعدة «الحمل على المعنى»
قاعدة «الحمل على المعنى» هي إحدى القواعد الأدبية التي تُستخدم في تفسير النصوص الدينية، ولا سيما الأحاديث. وتفيد هذه القاعدة بأن بعض العبارات أو الجمل قد تُحمل على معنى يتجاوز ظاهرها، بحيث يُستنبط منها معنى أعمق وأدق. وقد استُخدمت هذه القاعدة في تفسير حديث المنزلة («أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»).
تطبیق القاعدة على حديث المنزلة
في حديث المنزلة، العبارة في حديث المنزلة، توجد العبارة «إلا أنه لا نبي بعدي» (إلا أنه ليس هناك نبي بعدي). وقد استند السيد (وسائر علماء الشيعة) إلى قاعدة «الحمل على المعنى» في حمل هذه العبارة على «إلا النبوة» (إلا النبوة). وهذا يعني أن الاستثناء في هذا الحديث يقتصر على مسألة النبوة، بينما تبقى سائر وجوه التشبيه، كالأخوة، والوزارة، والخلافة، والنصرة.
معنى الحديث بحمل على المعنى:
“الإمام علي (عليه السلام) من جميع الجوانب مثل هارون بالنسبة إلى موسى، إلا في النبوة، لأنه بعد النبي محمد (صلى الله عليه وآله) لن يأتي أي نبي.”
في هذا التفسير، الاستثناء يشير فقط إلى الفرق في مسألة النبوة، بينما تبقى سائر وجوه التشبيه (مثل الأخوة، والوزارة، والخلافة، والنصرة).
نماذج قاعدة «الحمل على المعنى» في كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطي.
سيد رحمه الله في توضيح هذه القاعدة، استند إلى نماذج من كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطي. هذا الكتاب هو من المصادر المهمة في علم الأصول والأدب العربي، حيث يتناول قواعد اللغة والتفسير. في هذا الكتاب، تم تقديم العديد من الأمثلة على حمل العبارات على معانٍ أعمق وأكثر دقة، التي يمكن أن تُستخدم كأدلة لقاعدة «الحمل على المعنى».
الأمثلة المذكورة في الكتاب:
1-حمل العبارة على المعنى المجازي:
في بعض الحالات، تُحمل العبارات على معانيها المجازية. على سبيل المثال، قد تُستخدم عبارة «أسد» للدلالة على الرجل الشجاع.
٢. حمل الجملة على معنى أعمق.
في بعض الجمل، يُحمل المعنى الظاهر للجملة على معنى أعمق. على سبيل المثال، عبارة «لا نبي بعدي» قد تُحمل على معنى التأكيد على ختم النبوة وانتهاء سلسلة الأنبياء.
بِاستخدام قاعدة «الحمل على المعنى»، تُحمل عبارة «إلا أنه لا نبي بعدي» في حديث المنزلة على «إلا النبوة» (إلا النبوة). هذا التفسير يُظهر أن الإمام علي (عليه السلام) من كل النواحي مثل هارون بالنسبة إلى موسى، ما عدا في مسألة النبوة. وتعزز هذه القاعدة بالاستناد إلى النماذج المذكورة في كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطي، وتُقبل كأصل أدبي وتفسيري.
قاعدة «الحديث يفسر بعضه بعضاً»
هذه قاعدة حديثية. قد استند السيد في بعض بحوثه، عندما كان يستدل بحديث أو يرد قولًا ما، إلى هذه القاعدة. على سبيل المثال:
استدلاله على دلالة «مولى» في حديث غدير:
سيد باستخدام ألفاظ مختلفة أخرى التي تدل بشكل أوضح على معنى «الأولوية في التصرف»، بحيث تفسر تلك الألفاظ لفظ «مولى» في العبارة «من كنت مولاه فهذا مولاه».
استدلاله بالأدلة والشواهد المؤيدة لحديث «أنا مدينة العلم»:
سيد باستخدام الشواهد والمؤيدات لحديث «أنا مدينة العلم»، رد تأويل يوسف واسطي للفظ «علي» في الحديث. كان يوسف واسطي يعتقد أن معنى «علي» هو «العلو والارتفاع»، لكن سيد باستخدام هذه القاعدة بيّن المعنى الصحيح.
كبار علماء الحديث مثل حافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» أيضًا استندوا إلى هذه القاعدة في شرح الأحاديث وبيان معانيها.
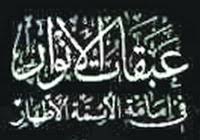
قاعدة «لزوم حمل اللفظ المشترك في حال فقد المخصص على جميع معانيه»
تنص هذه القاعدة على أنه إذا كان للفظ عدة معانٍ (لفظ مشترك) ولا يوجد قرينة لتخصيصه بأحد المعاني، يجب حمل اللفظ على جميع معانيه.
سيد في الاستدلال بالحديث:
«إن علیاً مني و أنا من عليّ و هو ولي كل مؤمن من بعدي»
«إن علیاً مني و أنا من عليّ و هو ولي كل مؤمن من بعدي»
استند إلى هذه القاعدة. في هذه الحالة، يُحمل لفظ «ولي» على جميع معانيه، بما في ذلك «الأولوية في التصرف»، بعد أن يتم التنازل عن تبادر هذا المعنى بشكل خاص في هذا الحديث الشريف.
لذا، حتى إذا تم بيان معاني مختلفة لكلمة «ولي» — سواء كانت هذه المعاني موجودة فعلاً أو تم اختراعها للتحريف والانحراف عن المجتمع — في جميع الأحوال، عندما لا توجد قرينة يمكن للمخاطب من خلالها التمييز بين المعنى المقصود من المتكلم، وفقًا لهذه القاعدة، يجب أخذ جميع معاني كلمة «ولي» في الاعتبار وحمل الكلمة على جميع تلك المعاني.
على الرغم من أن تبادر كلمة «ولي» إلى معنى «الأولوية في التصرف» هو أمر طبيعي (والتبادر نفسه دليل على صحة هذا المعنى)، إلا أنه حتى إذا تم التنازل عن التبادر، فإن أحد معاني «ولي» بالتأكيد هو «الأولوية في التصرف»، ويجب حمل هذا المعنى أيضًا على كلمة «ولي». لذلك، هذه الرواية تدل بشكل قاطع على أن أحد معانيها هو «أولوية التصرف للأمير المؤمنين علي (عليه السلام) على جميع المؤمنين».
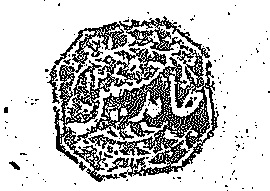
الكلمة الأخيرة
كتاب «عبقات الأنوار» للمير حامد حسين هو أحد الكنوز الفكرية والعلمية في تاريخ الشريعة والمعرفة الإسلامية، الذي يمكن أن يقدم نظرة جديدة وعميقة لفهم دلالات الحديث والتفسير. بأسلوبه المنهجي الدقيق والمبني على المبادئ العلمية، يقدم هذا الكتاب، خاصة في نقاشات ولاية الإمام علي (عليه السلام) والأحاديث المتعلقة به، رؤية أعمق من التفاسير البسيطة والسطحية، مما يؤدي إلى فهم أعمق وأكثر دقة.
نظرًا لأن آثار مير حامد حسين من الناحية العلمية والتفسيرية لها أهمية كبيرة في توضيح المفاهيم المعقدة في الحديث والفقه، فمن الضروري أن يتم إيلاء مزيد من الاهتمام لتعريف ودراسة أعماله. يجب على الباحثين والمهتمين بمجال العلوم الدينية الاستفادة من هذه الكتب لكي يتمكنوا من فهم الأبعاد المختلفة لعلم الحديث والتفسير بدقة أكبر واتخاذ خطوات إضافية نحو توضيح تاريخ الإسلام.
لكن بعيدًا عن المحتوى العلمي لهذا العمل، هناك سؤال كبير أمامنا: هل تم التعرف على هذا الكتاب ومنهج مير حامد حسين بشكل كافٍ في المجتمع العلمي والديني؟ هل استفدنا من هذه القدرة الكبيرة في توسيع المناقشات العلمية؟ يجب أن تستمر هذه المناقشات ليس فقط في الأوساط العلمية، بل أيضًا في الفضاء العام والإعلامي.
هذا النص هو مجرد بداية لحوارات أكثر. سواء كان ذلك معارضًا أو مؤيدًا، يمكن للجميع من خلال تقديم آرائهم ووجهات نظرهم، أن يخلقوا حوارًا مثمرًا ومنظمًا. ندعوكم لمشاركة آرائكم في التعليقات، ونقدها ومراجعتها، ومشاركة هذا النص مع الآخرين. من خلال هذا النقاش والحوار، يمكننا أن نصل إلى فهم أعمق وأفضل لهذه الأعمال العلمية والمنهجية، وفي الوقت نفسه الاستفادة من إمكانيات علمية في هذه المناقشات. إنها فرصة لا يجب أن نضيعها.
الكاتب: حامد صارم
تم إعادة كتابة هذا النص استنادًا إلى كتاب “نفحات الأزهار ” تأليف آية الله سيد علي ميلاني. في هذه الإعادة الكتابية، تم تقديم المواضيع الرئيسية مع تغييرات في طريقة العرض وإضافة شروحات تفسيرية لتحسين الفهم العام للمفاهيم التي ينقلها النص. في الوقت ذاته، لم يتم إجراء أي تغييرات كبيرة في المحتوى الأصلي، ويُعتبر هذا العمل بمثابة تحليل وإعادة كتابة جزء من مقدمة الكتاب المذكور.
المنهجية: في هذا المقال، تم السعي إلى استخدام المصادر الأصلية للكتاب وتفسیراتي الشخصية بشكل متناسق، مع الحفاظ على احترام الحقوق المعنوية للمؤلف الأصلي. تمت إعادة صياغة بعض الجمل بطريقة أكثر بساطة ووضوحًا، كما أُضيفت بعض النقاط التفسيرية الجديدة.
الخاتمة: يُقدَّم هذا النص كإعادة صياغة وتحليل لكتاب نفحات الأزهار، بهدف تسهيل فهم المفاهيم الأساسية وتكييفها مع احتياجات المجتمع المعاصر، مع الالتزام الكامل بحقوق المؤلف الأصلي.